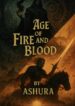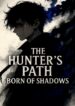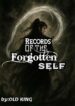شرح أختبار الجاهزية.
مقدمة:
أعلم عزيزي، أن الرواية ككل الفنون، لها قواعدها وأنظمتها ومدارسها. ولكن وككل الفنون أيضاً، تُخطئ أحياناً في قشورها وشكلها، ويهمل جوهرها ومضمونها.
ولا يهم أكنت مرتجلاً (pantser)، أم مخططاً. فإن الاسئلة التالية، يجب أن تفكر فيها وتعلمها قبل كتابة قصتك. ولا تخطئ أعانك الله الظن، وتعتقد أن الرواية هي الشاعرية، والكلام الجميل. فشاعرية بلا مضمون، وجمال بلا معنى، كالحلوى جميلة التغليف، فارغة المحتوى.
وأرى، أن أسس الكتابة الثلاث، لا تقوم إلا بهم، هي: الفرضية، الصراع الداخلي الواضح للشخصيات، وجودة الحبكات الثلاث والنهاية. وعلى الأسس، تبنى القصة وتهيكل وتعرض للقارئ.
وهذا، مثلاً: تجده ظاهر في كتابة أبو كرومبي. فإن سألت، أو قرأت. ستجد أن الحبكة واضحة، والقصة بسيطة في مظهرها، ولكن لأن الفرضية، والصراع الداخلي، والشخصيات، أقوياء ومتماسيكن. فكتاباته جيدة ومشهورة. ولا أقول، ولا يفهم من كلامي أن الباقي؛ من قصص عميقة، وحبكات قوية ومعقدة، وعوالم واسعة جلية، لا تهم. ولكن لا تقوم الأبراج إلا على أثبت الأسس. ولا يمكن أن تبنى قصة على أساس ضعيف.
وأعلم عزيزي، أن إجابتك عن هذا الاختبار وألف اختبار مثله، لا يعني أنك ستكتب أفضل القصص، ولا يغطي هذا الاختبار إلا بعض الأساسيات التي أرى كثيراً ما تهمل، ويوجد أساسيات أخرى، وتفاصيل عديدة، تفي لمئة سؤال لم اكتبها هنا أو اتطرق لها. وهذا الاختبار يعرض جزءاً وشكلاً من الجاهزية لكتابة قصتك، ولا تنظر للمكتوب وتأخذه على أنه قواعد مسلم بها، بل بعضها قد يكسر. والكتابة فن، والفنون لا تقيد وتغلل بقواعدها.
ملاحظة أخيرة قبل أن نبدأ: الهدف من الاختبار الاظهار لا الإلزام. فيمكن في الكتابة كسر قواعد عديدة وكثيرة، ويمكن أن تفعل ما تريد- بعد أن تعي الأساس بالتأكيد. والتالي يحمل بعض آرائي الشخصية (طبعاً يعني). وعلى الكاتب أن يفكراً بهذه، قبل أن يبدأ يكتب: الفصل الأول، لرواية كذا وكذا. ويطبقها كما يريد ويراها مناسبة. وكما قلت، ما هذه إلا بضعة أساسيات، ليست كلها. وبإذن الله سوف أكتب أكثر عن الشخصية وأحللها، والحبكات، والعوالم أكثر لاحقاً.
وهنا السؤال الأول: هل تعرف ماهية فرضيتك؟
والفرضية (premise) هي:
جملة، تلخص فيها أو تظهر معنى قصتك. تحوي رأيك أو نظرتك حول موضوع معين، وليست رسالة: فهذه ترسل واتس. بل فكرة تناقشها عبر قصتك، باختصار: معنى القصة. ومثال عليها: فرضية أغنية الجليد والنار: السلطة والسعي خلفها، يفسدان أنبل القلوب. فهذه الفرضية، هي رأي جورج مارتن حول السلطة، والسعي خلفها. يناقش افكاره، وتظهر الفرضية في كل جوانب الأغنية.
يمكن أن تخرج بها من سؤال ماذا لو، أو يخرج سؤال ماذا لو منها. تبنى عليها الشخصيات والعالم والقصة.
ولكن سأشرح الفرضية والهدف أولاً. الفرضية الجيدة، تكون كالنور الذي يرشد الكاتب في مسعاه، تُظهر وتنير كل شيء (قصة، شخصيات، عالم، مشاهد، حوارات، ثيمات.). فمن المستحيل وإن كتبت خمسة مشاهد على الأقل، إن لم تسأل نفسك: وماذا بعد؟. الفرضية تخبرك بماذا بعد. وماذا قبل. وقلنا أن الفرضية تخرج من سؤال ماذا لو، أو يخرج منها. فككل الفنون، قد تختلف البداية لكل كاتب. ولا توجد قاعدة تفرض أول الإلهام. ولكن، قبل أن نكمل، سأعرّف سؤال ماذا لو الجيد:
ويقوم على ثلاث:
1- أن يكون مثيراً للاهتمام، فإن كان: ماذا لو ذهب احمد إلى البقالة، ولم يجد لبن. إذا؟ ما المثير في السابق؟. ولكن أفترض: استيقظ أحمد ليجد المنزل فارغ، فلا والد باقي ولا اخت. هذا مثير للاهتمام، فلا يحدث كل يوم.
2- وأن يقترح صراع: في السؤال السابق، هل يوجد صراع؟ لا أحد يدري، قد يكون أحمد طفل صغيراً فبكى، ليس صراعاً، أو قد يكون أحمد جائع، أو، ألف أو مختلفة، السؤال الجيد يجب أن يحدد الصراع، ويظهره، ويوضح سبب مناسبته للشخصية والقصة. فلو لو قلنا أن أحمدا ذا إعاقة، ويحتاج أحداً يساعده. الآن هناك صراع.
3- أن يظهر التأثير (لماذا قد اهتم، ولماذا يؤثر على البطل) ويكون محددا: ففي السؤال السابق، ما التأثير على أحمد؟ وهل هو محدد؟ لا. فقد يكون التأثير نفسي، أي أنه لم يعتاد ألا يجد احد يساعده. ويحس أنهم تخلوا عنه، أو قد يكون التأثير جسدي فلا يدري كيف يتعامل مع الوضع وحده. وقد يكون خليط، وتقول أن احمداً كان رياضي، فلم يعتد حياة العجز هذه. أما عن التحديد، فما إعاقته بالضبط؟ أهي دائمة؟ أم مؤقتة كأن يكون مكسور اليد والقدم بسبب حادث؟. فإن افترضنا أن الإعاقة مؤقتة، وأن التأثير نفسي فيحس أنه اثقل على اهله، وجسدي فلا يدري كيف يتعامل مع الوضع وحده. وأهم نقطة في السؤال الجيد، وأن تظهر التأثير. تظهر لماذا هذا الحدث، مؤثر على الشخصية، فإن افترضنا أن احمداً ليس برياضي، وهو كسول ملازم سريره دائماً، فالكسر نعمة لا نقمة. وإن صاحبته الآلام الآن. فهذا يهدم التأثير، بل يجب على الصراع الجيد أن يظهر التأثير بعينه للشخصية.
والآن لنصيغ السؤال:
ماذا لو أن رياضياً يفتخر بإدائه العظيم كُسر في حادث قبل البطولة بأربع شهور، فلازم السرير. استيقظ ليجد أن أباه واخته اللذان رعياه لأسبوع تخليا عنه، وأنه ترك وحده ليتعامل مع حالته الجديدة؟
السؤال السابق، يظهر الكثير بالفعل، ويرشدك أين تكتب وتتعمق (الأب والأخت، وعلاقة البطل بهما، فخره بجسده، تاريخه الحافل، رياضيته وسمعته، هدفه (التعافي قبل البطولة)، محل الصراع، بعض من الثيمات). ويعتبر اساسا جيداً تبنى عليه القصة، ولكنه ليس الفرضية، ولا يرشدك في كتابة الأحداث مثلها. فالسؤال، يمكن أن يجيب عليه عشر بعشر طرق مختلفة، وتبنى عليه فرضيات عديدة.
من السؤال السابق، ممكن ان نستخلص فرضيات عديدة، مثلا: أن الاعتماد على النفس هو دائماً السبيل، أو الاعتماد على الأخرين سيء، أو الاعتماد على الأحباء نهايته الألم، أو في الشدائد تعرف المعادن. أو ألف فرضية أخرى. وبعض السابق جيد، وبعضه سيء. فكيف تحدد الفرضية الجيدة؟.
كسؤال ماذا لو، الفرضية الجيدة توضح الصراع. ولكن صراع الفرضية أعم من السؤال. وأيضاً، يجب أن تكون محددة، وليست عامة مشتتة، فلا يقال: الحب سيء. وتعتبر فرضية جيدة، بل تحدد ما السيء في الحب، وأي حب هو. أحب الاصدقاء وخذلانهم؟ أم حب الأخوة والعائلة؟ أم حب الزوجة والأبناء؟. وتحدد ما السيء فيه. فحسنها يأتي من قطيعتها. فلا تقول: السلطة والسعي خلفها يفسدان أنبل القلوب، ثم تركك شخصية نبيلة غير متأثرة بفرضيتك، لا بل يجب أن تكون الفرضية كالقانون الأعلى في روايتك. لا يمكن أن يخرج عنها أحد، إلا لإثباتها عكساً. وهذا ما سيأتي شرحه.
ففي السابق، عرفت ما السيء صحيح؟. الاعتماد على الأخرين سيء، لماذا؟ لأنها عامة. وايضاً، الاعتماد على النفس هو دائماً السبيل، سبيل ماذا؟ النجاح؟ الفشل؟ الألم؟. يجب أن تحدد وتكون قطعية. فالجيدة بينها: الاعتماد على الأحباء نهايته الألم.
فتقترح صراع، وهي محددة، وأيضاً قطعية. فترشدك في كتابتك، فتعلم من الفرضية التي تريد أثباتها، ماذا سوف تكون نهايتك: ألم. وسوف ترشدك في كتابة الاحداث.
وأعلم عزيزي، أن الفرضية لا يجب أن تكون سؤال فسفلي، أو فكرة عميقة تمحصّها من المجتمع والمحيط وتكتب عنها، لا. بل أي رأي من آرائك عن العالم، عن النفس البشرية، عن موقف من موضوع تتخذه. يمكن أن يحول إلى فرضية تبنى عليها قصة، ولا يجب أن تكون القصة جواباً لهذا الرأي، بل مجرد استكشاف، وعرض. أي لا تقنعني به، لكن اجعلني افكر فيه.
السؤال الثاني: هل تعرف صراع البطل الداخلي مع فرضيتك؟.
أعلم ماذا موقف بطلك من الفرضية، أيقبلها؟ أيرفضها؟.
لكن قبل: ما هو الصراع الداخلي؟. الأمر بسيط، وتعريفه سهل: هو موقف بطلك السابق للرواية، المعارض للفرضية. فمثلاً، افترض أن خوينا أحمد لم يهتم بأن أحبابه تخلوا عنه، ومن سريره أتصل على خادم يعينه، وانتهت المشكلة، الآن أين الصراع؟. لا يوجد، كما قصتك.
ولكي لا تجعل القارئ يتساءل، لماذا لا يتصل على خادمة وخلصنا؟، يجب أن تتأكد من كتابة شخصية أحمد، وتحميله بالاعتقاد الخاطئ الذي يمنعه من أن يتصل على خادم ويحل المشكلة بسهولة.
فلو جعلت أن أباه وأخته، سرقوا ماله. أو هذا ما استبان له، فلما استيقظ وجد أنه بلا مال وأخت وأب، وحاول أن يتصل بهم وقلق عليهم ولكن بدون فائدة. ولنفترض أن احمداً، يرى التخلي، خيانة. وأنه تعب واجتهد وساعدهم سابقاً، والآن حين حاجته تخلوا عنه. وقيل أن كل بطل، يجب أن يدخل قصته محمل باعتقاد خاطئ يمنعه من رؤية الحقيقة، أو خللا يغرقه في الخطأ. ولنفترض أن أحمداً في قصته، اعتقاده الخاطئ؛ أن الأعمال الصالحة دائماً ترد، وأن اللطف والمساعدة يقابلها اللطف والمساعدة.
فهذا الاعتقاد يمنعه من تقبل الحقيقة (الفرضية) من أنهم تخلوا عنه، وأن اللطف لا يقابل باللطف بل بالسوء.
فتخيل أن لوقن ذا التسع أصابع، كان يحب وضعه وسمعته قبل الرواية، ولا يرى مشكلة فيها وفي شخصية التسع أصابع، ولم يحاول التغير. أين الصراع هنا؟ لا يوجد، حتى لو مر لوقن بكل ما حصل في الرواية، وعانى ذات المعاناة، ستكون بلا معنى لأنه لم يعاني داخلياً، لم يتصارع مع الفرضية ولم يتصارع مع نفسه وماضيه ومستقبله وحاضره.
فالفرضية الجيدة، تظهر دائماً، الصراع. وصراع البطل الجيد هو صراعه الداخلي، ولا نهمل الخارجي طبعاً، ولكن الآن سنركز على الداخلي. فمثلا: في الاغنية، إحدى البطلان: دينيريس: من بداية الرواية، وحتى آخرها، تتصارع مع الفرضية رفضاً، في حين قلوكتا في القانون الأول يبدأ وهو “متقبل” للفرضية، ولكنه يتصارع معها أيضاً، ففي الكتب الثلاث تراه يتساءل حقاً ويختبر الفرضية، وهو مدرك متقبل لها.
فالآن أفترض خوينا أحمد، يرفض الفرضية (الاعتماد على الأحباء نهايته الألم). ليس لإدراكه بها، لكنه لا يعلمها، وادركها مع تقدم القصة ورفضها. ولنفترض أنه رعى أخته قبلاً، وساعدها في مرضها وعافيتها، وساعد أباه في ماله وأبناءه. ولكنه استيقظ ليجدهم تخلوا عنه، الآن، ألن يتصارع مع الفرضية؟. مؤمنا بأنهم لن يتخلوا عنه، ومع الأحداث وتقدم القصة يوقن أنهم بالفعل تخلوا عنه، الآن ماذا سيحدث؟ هل سوف يقبل الفرضية، ويتخلى عن آماله بأحبائه والمقربين منه؟ أم سوف يرفض الفرضية حتى يضرب ضربة تجعله ينهار أو قد يموت؟.
فمثال لشخصية رفضت الفرضية حتى النهاية، مع إدراكه به هو شخصية لوقن ذا التسع أصابع، عرف الفرضية، ولم “يرفضها” حقاً، بل حاول مقاومتها. حتى نهاية القصة ومن قرأها يدرك ماذا حدث.
وأعلم عزيزي، انك لا يمكن أن تناقش أو تعرض أكثر من فرضية وصراع داخلي رئيسي في قصة واحدة (طبعاً، الصراعات الفرعية مع الحبكات الفرعية، موجودة ولازمة، وسأفيض فيها في نقطة الحبكات)، بل ألتزم واحدة. فكما لا يمكن أن تطبخ أكلتان في ذات القدر، لا يمكن أن تناقش صراعين رئيسيين في قصة واحدة، وإن تعددت شخصياتها.
السؤال الثالث: هل تعرف ماضي بطلك؟.
لما قلنا أن القصص هي الصراع، وتأثيرها يأتي من التغير الداخلي، كيف ممكن أن تعرفهما إن لم تعرف الماضي؟. كيف تعرف ماذا بعد، إن لم تعرف ماذا قبل؟. فيجب أن تعرف بطلك، وتضع فيه اسباب تصرفاته اليوم (أي القصة)، وكيف وصل إلى هنا. وإن عرفت وأظهرت الماضي، ستعرف الصراع ويظهر التأثير في القصة. لأن من المستحيل أن تتغير من شيء إلى شيء، وأنت لا تعرف مما يتغير. فكما في القانون الأول، لوقن ورحلته في القصة مؤثرة، من ماضيه، وما يظهره الكاتب منه. فإن لم نعرف ماضي لوقن كيف ممكن أن نتأثر في حاضرة ومحاولته للتغير؟.
وماضي بطلك، يجب أن يحوي اعتقاده الخاطئ، وشبحه (السؤال السابع)
ويحبب، وهذه نصيحة: أن تعظم تأثير ماضيه على حاضره وواقعه وصراعه اليوم. فقلنا، لو كان أحمد دباً كسولاً، لا يقوم من سريره، فلا صراع عندك من حادثته (القصة). وقد تقول: لماذا لم نعجل أحمداً عادي؛ رجل يقضي يومه مثلنا، وليس رياضي مشهور؟. فكلا الحالتين، سوف تسببان بصراع مع حالته الحالية، وهذا صحيح. ولكن السبب، هو تعظيم الصراع. فصحيح لا يقدر الشيء إلا فاقده، ولكن ولأجل القصص يفضل أن تعظم تأثير الفقد. لكي تعظم التغير في النهاية.
فمثلاً: رجل غني، لم يمضي يوما إلا وكل المأكولات الشهية أمامه، ويأكل وينهش فيها كما يرغب بلا ضرر (مادي). ورجل عادي، يأكل يوما ويجوع يوماً. أيهما لو افترضنا القصة عن الفقر، وتغير الأحوال سوف يوضح أكبر تغير وتأثير؟. أكيد الغني. كلاهما سوف يتأثران بتغير الحالة وسوءها، ولكن الغني سوف يتأثر اكثر لاعتياد الرجل العادي على الحياة الصعبة.
وهذا ينطبق على أحمد، فلأنه رياضي مشهور، يكسب ماله وشخصه وحياته من جسده، ويعلم قدراته ومدرك له، سوف يتأثر من حادثة تكسره، أكثر من غيره، ولو تأثر الأثنان بها.
(ولكن احذر، عزيزي، فلا تجعل أحمد بطلاً خارقاً لكي تظهر التأثير وتعظمه، فلا حاجة لأن تعظم التأثير لهذه الدرجة، إلا لو كانت هذه قصتك).
السؤال الرابع: هل تعرف حبكتك الرئيسية؟
في كل القصص حبكات عدة، ولكن البعض يخطئ ويظن أن حبكته الفرعية هي الرئيسية، وتهيمن على نظره ويعمى بها، فيظن أن الأحداث الجسدية للشخصية، هي الحبكة الكبرى، وهي الأمر الذي يجب أن يركز عليه، وهذا خاطئ (بنسبة 99%). فالحبكة الرئيسية يجب أن تكون الداخلية (الصراع)، وإن هيمنت الجسدية على الصفحة.
فالحبكة الرئيسية، تكون حبكة الفرضية والصراع معها، ولا تكون الصراع الجسدي للشخصية من عقباتك وعالمك، ولا مع الشخصيات الأخرى؛ الصراعات هذه مهمة، لازمة، لكنها لا تؤهل لتكون الصراع الرئيسي الجوهري الذي فيه تكمن وتحل عقد القصة.
قد تسأل عزيزي: شخصيتي قوسها ثابت، ولا تتغير مع مرور القصة، ولا تتصارع مع الفرضية بل تبدأ القصة وهي متقبلة لها، فماذا يكون صراعي الرئيسي؟. الجواب سهل: تأثير شخصيتك الرئيسية بالفرضية على الشخصيات الثانية، والعالم المحيط فيه، هو صراعك الرئيسي. لأن لو بدأت قصتك، والكل متقبل للفرضية، أين الصراع؟ أين القصة؟.
فمثلاً، في قصة خوينا أحمد، قد تُخطئ معاناته، ومصاعبه الجسدية، على أنها حبكته الرئيسية، ويهمل صراعه الداخلي (الخذلان وشعور الخيانة؛ كلا الجسدية( عجزه) والنفسية (تخلي أبوه وأخته عنه.). ولكن هذا خاطئ، فيمكن لأي شخصية أن تمر بمصاعب جسدية، ولكن ما يميز أحمد، هي معنى هذه المصاعب له، وكيف أنها تؤثر وتغير في شخصه.
فمثلاً، في القانون الأول، لماذا المصاعب التي يواجهها لوقن معبرة جداً؟ لأنها تنبع مباشرة من صراعه (شخصية ذا التسع أصابع) وماضيه. وصحيح أن أغلب الأحداث التي تقال من وجهة نظره عن الرحلة وأصحابه فيها، ولكن ليست الرحلة وأهميتها هي الحبكة الرئيسية للوقن.
السؤال الخامس: هل بطلك وتغيره الداخلي ملمح له، وواضح، ومؤثر.
إن لم يكن الصراع واضح، وملمح له، ومؤثر، إذا إما عندك صراع ضعيف أو شخصيات سيئة.
الصراع، كزيت القصة، هو الذي يدفعها للأمام المحرك الرئيسي الذي يمسك قارئك ولا يدعه يترك القصة. هو الذي يجعله يسأل: ماذا سوف يحدث بعد؟ ماذا سيفعل البطل؟ كيف سوف ينجو؟.
ومثال على شخصية تغيرت تغير جيد، وواضح ومؤثر. هو تغير شخصية جيمي لانستر من الأغنية. أو شخصية جيزيل من القانون الأول. تغيروا من شخص لآخر، بسبب الفرضية وصراعها معها، فجيمي تغيره كان، وتنبيه حرق:
من صراعه مع الفرضية: السلطة وسعيها يفسدان أنبل القلوب، فلما فقد سلطته، ولو داخلياً، تغير نحو الأفضل، وهذا إثبات “عكسي” لفرضية جورج. لما تخلى عن سعيه للسلطة (جيمي سعى للتقبل والحب أكثر من السلطة، ولكن حبه تطلب سلطة، وتقبله كذلك)، تغير وتحسن نحو الأفضل.
ومثال على تطبيق سيء لهذا، وإن زرع المؤلف بذور التغير في بطله، وكان تغيره واضح، ولكن ليس مؤثر؛ بسبب أن المؤلف استعجل في التغير وتبيينه هو: شخصية باول من دون (الكتاب الأول). فتغيره، ملمح له، ووضح تأثيره عليه، ولكن بسبب أن الكاتب لم يجعلك تمر مع البطل بهذا التغير، بل تخطى إلى البطل المختلف (في الكتاب الأول) التغير يشعرك أنه غير مستحق.
وأفترض لو خوينا أحمد، بعد صراعاته العديدة، وحين تغيره، أخبرك الكاتب أنه تغير، ولم يعد يثق بأحبائه وقدرتهم على مساعدته، ثم أظهره وهو يثق بعزيز ثانية؟. أو مثلاً، بعد الفصل الأول، لما استيقظ أحمد ليجد نفسه وحيداً في منزله، تغير مباشرة، وصار يكره أباه وأخته، كأنه ينتظر لهما الزلة؟.
ومثال على شخصية تغيرها لم يكن واضح، ومؤثر، وملمح له، هو تغير شخصية: كانوت من فينلاند ساغا، فتغيره كان سريع، جذري، وغير ملمح له ومؤهل من الشخصية والأحداث التي حدثت لها في القصة وعرضها. بل بدا أن تغيره كان لأن الكاتب أخبره: تغير، فتغير. وأيضاً، البطل ثورفين، تغيره جذري، وثابت جداً. ولم يشكك بطرقه الجديدة ولو لمرة ( في الموسم الثاني)، وأيضاً، لم يقدم الكاتب تغيره ببطء (وإن كان تغير بعد قفزة زمنية، يجب عليه زرع البذور في الموسم الأول، ثم يغير ويحوله بعد القفزة الزمنية، ولا يجب أن يشعرك أن: أها، لما ما كنت تطالع، سويت كل شيء). بل تحوله كان مباشراً غريباً، لا أراه يكتب هكذا.
السؤال السادس: هل تعرف الفرق بين؛ الاعتقاد الخاطئ، والشبح، والرغبة، والاحتياج، والصراعات، للشخصية؟ وكيف ينتجون هدفها؟.
فالاعتقاد الخاطئ: هو اعتقاد خاطئ حول الفرضية، يظهر ويبرز في ماضي الشخصية، وهو ما يقودها والقصة وسبب تصرفاتها والصراع الرئيسي مع الفرضية، فمثلاً: اعتقاد احمد الخاطئ: أن اللطف باللطف، والاحسان بالإحسان وهذا الاعتقاد “الخاطئ” لا يجب أن يكون خاطئاً، فاعتقاد احمد صحيح، لكن في محيطه مثلاً، أو يمكن لعائلته السيئة؛ هذا الاعتقاد خاطئ فيها. ولكنه الآن، هو مصدر الصراع الرئيسي مع الفرضية: الاعتماد على الأحباء نهايته دائماً الألم.
ويجب أن يكون الاعتقاد الخاطئ منطقي للشخصية، مناسب لماضيها، فمثلاً، إن افترضنا في ماضي أحمد، أمه ولا عمه، ولا شخص عزيز عليه، اعتنى فيه، وساعده دائماً، ودائما في تصرفاته وأفعاله، يرى احمد الاعتقاد. فزرع فيه هذا الاعتقاد “الخاطئ”.
ولكي تفهم الاعتقاد الخاطئ، وتتأكد من أنه يناسب بطلك وفرضيتك، وماضيه ومحيطه. اكتب المشهد الذي تجذر فيه الاعتقاد الخاطئ، وصار من يقود شخصيتك.
الشبح: هو شخص، أو شيء، أو حدث، أو شعور، أو فكرة، تطارد شخصيتك. والشبح، لا يلزم أن يكون حدث درامي تراجيدي، ولكن يجب أن يكون الشبح ظاهراً في تصرفات شخصيتك، فمثلاً: شبح شخصية سيرسي لانستر، هو: فقدان السيطرة والحب.
وأحد الاشكال التي يظهر فيها هذا الشبح، في أخيها تيريون، فهو مصدر افعال كثيرة لسيرسي، وتراه يلوح في أغلب تصرفاتها، سواءً الماضية، أو الحاضرة. وشبحها مؤثر عليها ويقودها في قرارات كثير، بالذات في الكتاب الرابع.
أما الرغبة: هي ما تُعده الشخصية حاجتها ورغبتها التي تسعى لتحقيقها. فهي نتاج الدمج بين الفرضية، والشبح، والماضي. تتشكل رغبة الشخصية، وبالعادة رغبة الشخصية تكون ما يضرها، مثل سيرسي لانستر، فرغبتها كانت أن تكون الأقوى، الأذكى الأجمل، وظنت أن صارت الملكة (هدف من: الرغبة + الفرضية + الشبح + الاعتقاد الخاطئ)، سوف تحقق رغباتها.
ولكن؟ كل السابق ضرها اكثر مما افادها، وسعيها الاعمى لهذه الرغبات هو سبب ما حدث لها في النهاية.
مثلاً خوينا أحمد: قد يكون هدفه، هو معرفة ماذا حدث وأين ذهب أبوه وأخته، وانتظاره لهم على الرغم من تخليهم عنه، ثم الاعتقاد ان سبب تخليهم بسبب وضعه الحالي، وأنه لا قيمة له غير جسده ومهنته. فيعتقد أنه لو تحسنت حالته الجسدية، ورجع لمهنته سوف يتقبلونه (الرغبة). فيصير هدفه -مثلاً- حتى نصف او ثلاثة ارباع القصة هو: تعجيل شفائه. وعودته وإن ضره هذا (هدف من: الرغبة + الفرضية + الاعتقاد الخاطئ).
أما الاحتياج، فهو ما يحتاجه حقاً، وما يجب ان يتقبله لكي لا يدمره هدفه. وغالباً، يكون ما نصته الفرضية، وإن لم تتقبل الشخصية احتياجها، وتجاهلت وسعت نحو رغبتها سوف تهلك أو يحدث لها شيء فظيع وتدمر. فمثلاً، احمد يحتاج أن يتقبل أن أباه وأخته سيئان، ولا يجب ان ينتظر تقبلهم، ولا يسعى لرضاهم. وغالباً، تكون حل عقدة القصة في؛ تقبل الاحتياج هذا، اي عندما يتقبل احتياجه تكون بداية النهاية.
ولا يجب أن تكون الرغبة سيئة، والاحتياج جيد. أو العكس. فقد يرغب الشخصية بأن يصبح بطلاً، ولكن احتياجه يكون أن يتقبل ضعفه وعجزه وقلة حيلته في وجه محيطه (جيزيل من القانون الأول). أو تكون الرغبة بأن يصارع ويقاتل من أجل الحب والاحترام، ولكن حاجته بأن يتخلى عن حبه، ويقوم بواجباته (جيمي لانستر من الاغنية).
أو تكون الرغبة بأن يموت ويرتاح من عذابه الحالي، ولكن احتياجه بأن “ينظر للجانب المشرق من الكأس” ويتقبل أنه وضعه لن يتغير فعلى الاقل لا يجب ان يزيد على معاناته (قلوكتا من القانون الأول).
وما يحدد ماذا ينتصر، هو قوس الشخصية الذي تريده. فإن اردتها سلبية، جعلته يتحول من عنده احتياجه إلى مطاردة الرغبة وفي النهاية الدمار (سيرسي لانستر، البارون من دون)
أو إيجابية، فيكون من التحول من مطاردة الرغبة، إلى الاحتياج، وتقبله.
وطبعاً، اقواس الشخصيات كثيرة، وقد يكون في كتاب معين (إذا كانت سلسلة) إيجابي، ثم الكتاب التالي، سلبي، فمستوي، فتراجيدي… إلخ. ولكن، ارجوك، إن كانت قصتك الأولى، لا تبدأ في سلسلة من مليون كتاب، فكما مستحيل أن تقبل طلب المدير بأن تبني برجاً من أول يوم، أو تفتح أدمغة المرضى في المستشفى بلا خبرة ومعرفة كافية، لا تتوقع أنك ستضبط سلسلة طويلة من شخصيات كثيرة، في محاولتك الأولى وقصتك الأولى. فكما أن الدماغ أصعب الطب، السلاسل أصعب الكتابة.
ثم الاستعياب، أي ما تحتاج الشخصية فعله لكي تحول مسارها أو حياتها، من الرغبة إلى الاحتياج، الاستعياب سهل الكتابة. ويكون هو ثمرة كتابتك لكل السابق: الشبح والرغبة والاحتياج والاعتقاد الخاطئ والصراع معهم، نتيجته هي الاستعياب.
وأخيراً: الصراعات. الشخصيات الجيدة، تكون دائماً محملة بالصراعات، بعضها من الفرضية والرغبة والهدف، وبعضها من القصة والشخصيات الأخرى، وبعضها من العالم والبيئة المحيطة. ولا تحصر نفسك بعدد، ولكن ككل شيء لا تبالغ في العدد وفي الصراعات؛ فلا حاجة لمعرفة صراعات ومشاكل البقّال الذي سوف يظهر لمشهد، أو شخصية جانبية غير مهمة. ولا تجعل بطلك مختل عقلياً؛ يصارع الدود والنمل والغبار، ولا ترك شيئاً إلا وعنده صراع ضده.
فأفضل الصراعات، تكون محدودة بالفرضية (الصراع الرئيسي) والهدف، والرغبة، والحاجة والشبح.. إلخ. وأيضاً لا تنس المجتمع، فمتأكد أنه حتى أنت عزيزي القارئ، لديك مشاكل مع مجتمعك ومحيطك. فمستحيل أن توافق مجتمعك مع كل شيء، ولا يتطلب الصراع المجتمعي، أن يكون ” ثائراً” على المجتمع، أو فرد يحاول تغيره نحو الأفضل، لا، لا حاجة.
فمثلاً قد نجعل صراع احمد مع المجتمع، هي نظرتهم للرياضيين، وكيف بعضهم يقدسونهم مثلاً، أو كيف البعض يكرهونهم لكره فريقهم أو رياضتهم. أو أي نظرة اخرى قد تخرج من الشخصية (فضفاضة جداً حالية؛ لم اهتم ببنائها.)
ومن الروايات: صراع تيريون مع المجتمع: وأنه أين وكيف تولد، يحدد حياتك ومصيرك. أو مثلاً صراع لوقن مع المجتمع وسمعته اللطيفة جداً. أو صراع باول مع المجتمع وكيف أن أي شيء يقوله ويفعله، يقدسونها ويجعلونه رمزاً.
وايضاً وهذا تنبيه وتحذير، أحذر من أن تعميك الصراعات الخارجية عن الهدف، عن الصراع “الأكبر” وهو الصراع الداخلي. الذي يجب أن يكون الوقود الأول للقصة، الدافع والجاذب، الشيء الذي يمسك القارئ ولا يدعه يترك كتابك. فمثلاً، خوينا احمد، صراعه الداخلي: هو تخلي اباه وأخته عنه، وصراعه بين تقبل التخلي هذا، واعتقاده الخاطئ بأن اللطف يرد دائماً. وهذا الصراع يجب أن يكون وقود القصة، وعقدتها (الداخلية) التي بحلها تحل القصة، وتجعل أحمد إما يتحسن ويتخلى عن اعتقاده الخاطئ ويحتضن حاجته وتغيره نحو الأفضل. (قوس إيجابي)
أو رفض هذا الصراع، ورفض الفرضية، فما يزال يؤمن بأبيه وأخته، وانهما سوف يعودان. مما يجعله ينهار داخلياً، وقد يستعجل شفاءه، ويعود للمعلب فيصاب ثانية وهذه المرة قد يُشل تماماً، وتدمر مهنته ورؤيته لذاته.. (قوس سلبي).
ومثلا: سيرسي، التي تمسكت باعتقادها، وغلفها شبحها وعمتها رغبتها، حتى النهاية. وقود احداثها، كان صراعاتها الداخلية؛ وكيف أنها أذكى من الكل، وكيف أنها ستحكم بقضبة من حديد، وكيف أنها سوف تضارب الحمقى ببعض وتخرج منتصرة، وكيف سوف تحبك ألاعيبها حتى تبعد من لا تريد عن العرش، وتقرب إليها الحمقى، واقصت العقل. وغرقت بالخمر، والشهوة. ولامت من حولها لكل خطأ حدث، وهي تطارد أخاها الهارب وأخاها الفار. وبينما تحاول أن تصير تايون لانستر، تحاول أن تثبت أنوثتها (التي تكرهها) وتهيمن عليهم بعقلها العظيم الذي لا يطوله الرجال. كل هذا كان وقود احداثها، هو الذي (كرهني فيها صحيح) ولكن جعلني أريد أن اعرف أي حماقة بعد ستفعل، وأي جرم أكبر سترتكب.
وسهل أن تعمى بالصراعات الخارجية؛ بالعقبات، بالأعداء والاصدقاء، بالعالم والبيئة. ولكن لا تدعها تكون هي المحرك للقصة، لا تدع القصة تذهب من مشهد لمشهد، وصراعك الداخلي ثابت هامد. لأنك هكذا ستكون كتبت مجموعة مشاهد، لا قصة.
ايضاً، عزيزي لا يخطئنّك الظن، وتعتقد أن هذه هي “الطريقة الصحيحة” لبناء الشخصيات، لا وألف لا. لا يهم من أين تبدأ، فقد تبدأ من فكرة، أو مشهد، أو حوار، أو قصة، أو رغبة، أو فرضية. ثم تخرج بباقي المتطلبات، ولا يجب أن تأتي بهذه وتضيف رغبة واحتياج كالذي يتأكد من أنه اتى بكل طلبات البقالة. لا، ابدأ من حيث شئت، فقد تحب ان تكتب شخصياتك من مشهد، ثم ترجع لماضيه وتجد لماذا فعل هكذا، أو تبدأ من فكرة ثم تتوسع، أو تبدأ من صراع ثم تملئ الباقي. لا يهم من أين تبدأ أو كيف تجد هذه المتطلبات، أهم شيء، قبل أن تكتب: الفصل الأول، لرواية كذا وكذا. أن تتقين معرفة هذه الأمور.
السؤال السابع: هل الحبكات الثلاثة ظاهرة؟
طبعا، ستجدها بأسماء مختلفة، لكن الفكرة نفسها.
الحبكة، أشوفها تقسم لثلاث أنواع: خارجية (عقبات) + داخلية (صراع) = قرار (تغير)
فكل “نوع” منها، يركز على شيء، فالداخلية تركز على صراع الشخصية الداخلي مع؛ الفرضية، والشخصيات الثانية، والعالم، والعقبات التي تضعها.
أما الخارجية، فتكون الصراع الظاهري (الاحداث) مع السابق. ونتيجة هاتين حبكة “رئيسية”. يعني يمديك تقول أنها: فعل (العقبة) + ردة فعل (تأثيرها) = قرار الشخصية بكيف تخطيها.
فمثلاً: جيمي لانستر من الاغنية، وفي الكتاب الرابع، فـ #حرق.
لما قطعت يده، و ” خسر ” سطلته، ولو داخلياً، هذا هيأ حبكته تبدأ، لأن جيمي، يرى أن قيمته العظمى هي فارساً أبيضاً من حرس الملك، ولا يقدر ذاته على غير هذا، إلا حبه لأخيه وأخته. فلما انهار حبه. نرى كيف تعامل جورج مع حبكة جيمي ونقيسها على “الحبكات الثلاث”
الحبكة الأولى: الخارجية (العبقات).
مات أبوه، اخته ترتكب من الحماقات مالا يخيل لبشر، هرب اخوه. بينما يواجه كل هذا، يحاول أن يتعامل ويتفهم وضعه الحالي، سياف بلا يد، وفارسٌ بلا سيف. كل هذه العقبات، تصعب عليه أن يتعامل معها، ومع حقيقة قطع يده. كل هذه عقبات مع الصراع تشكل القرار الذي اتخذه جيمي نهاية الكتاب.
الحبكة الثانية: الداخلية (الصراعات).
قطعت يده، مات أبوه، اخته ترتكب من الحماقات مالا يخيل لبشر، هرب اخوه، صراعه مع الشرف وحقيقة التاريخ ولقبه. كل هذا، جعله يتساءل، عن كثير، فأعاد تقييم ذاته. ونظر لنفسه أنه بلا قيمة بلا سيفه، وأنه حاول أن يقتديَ بآرثر لكنه انتهى الفارس المبتسم. وأنه الملام على موت أبيه، فهو من اطلق الوحش، ومحاولته لتنظيم حرس الملك، ورؤيته لسيرسي من حماقة لأخرى، ومحاولته إقناعها بألا تفعل هذا، كل هذا وقد خسر نفسه، وسيفه، وكله غضب على سمعته وشرفه، وكيف أنه لم يقتل الملك لعباً. لم يقتله لأجل الشرف، لم يقتله لأجل أبيه، بل قتله لأجل المدينة والشعب.
الحبكة الثالثة: النتيجة (القرار).
يقرر جيمي أن يتغير، وأول خطواته بالتخلي عن سيرسي.
ملاحظة: لا تقدم الحبكات كلها في فصل، بل تتصاعد ويحل بعضها ويتعقد الآخر خلال الفصول، ويجب أن تمر الحبكات بهذه الخطوات (العامة، لها تفصيل): عقبة، صراع، نتيجة (قرار).
وطبعاً، لن تقف شخصياتك أمام كل عقبة لتنوح عليها، وتتصارع معها في حين قدرتها على تخطيها والقفز فوقها. بل الحبكات، تشكل من العقبات الكبرى، التي تتحدى جوهر الشخصية، فيتصارع معها ويحلها أو يغرق من تأثيرها.
السؤال الثامن: هل وضعت عقبات أمام شخصياتك، وهل هي جيدة؟.
فالعقبة، مهمة. بل قد يقال أنها أهم اداة لسرد القصص، فليست قصة إن خلت من العقبات (صراع). ولا يمكن أن تظهر الشخصية بلا تحدي ومصاعب، ولا عالمك سوف يظهر ويتميز و يحبه القارئ، إن لم يتحد شخصيتك بطريقة فريدة، ولا يمكن أن تظهر ثيماتك بلا عقبات.
وليس على كل العقبات، ان تتحدى جوهر الشخصية، بل بعضها يكشف جانباً منه، مثلاً تخيل لو ثلاث رجال أرادو قطع نهر، بعد جري أرهقهم. ومثلاً قائدهم، يقول سوف نستريح لخمس دقائق ثم نكمل، فهنا:
واحد منهم قرر أن يقطع النهر مباشرة، ثم يستريح الخمس دقائق هناك.
الثاني، استراح ولم يقطع النهر حتى انتهت الخمس دقائق.
الثالث، استخدم الخمس دقائق بأن يجد أسهل طريقة يعبر فيها النهر، ثم قطعه.
الآن العقبة ذاتها، اظهرت شيء مختلف في الشخصيات الثلاث، ولم تتحدى كيانهم، ولكنها تعتبر عقبة جيدة. ولكن التالي، عن العقبات الرئيسة للشخصية، العقبة التي تظهر الصراع مع الفرضية، وتبين جوهر الشخصية وتزرع بذور تغيرها.
والعقبة، ككثير، لها طبقات وشروط لكي تكون جيدة. وأظنها أربع:
الشرط الأول: هل هي حقاً عقبة؟.
فمثلاً، افترض لو أن خوينا احمد، صحى وهو حشر؟ يريد قضاء حاجته؟ أهذه عقبة؟ أكيد، لأحمد. ولكن لو وضعت نفس الشيء، لأي شخصية ثانية، هل يتحداهم؟ لا، طبعاً لا.
فمثلاً، افترض أن جيمي لانستر، في الكتاب الأول: هاجمه شحات فقير، ولم يتخف. أهذه عقبة له؟ طبعاً لا. ولكن لو ذات الفقير هاجم تيريون، الآن هذه عقبة وتحدٍ صعب عليه.
فإن تمكنت الشخصية من تخطي العقبة بسهولة شديدة، فليست عقبة، ويمكن أن تجعل من العقبات السهلة، التي لا تتحدى شيء، عقبة، عن طريق تصعّيبها مثل: أن تقفل الباب أمام من يريد قضاء حاجته، أو أن تجعل جيمي لانستر بلا سيف.
ثانياً: هل تُصّعد أو تظهر العقبات تأثير داخلي/ تثير مشاعر الشخصية.
فمثلاً، افترض كتبت عقبة خوينا أحمد، ولكن لم تظهر أي مشاعر وتأثير داخلي بسببها، الآن هل تعتبر هذه عقبة جيدة؟. لا، ليست جيدة ولا قريبة، لأنك اهملت شيء مهم، ماذا سوف تُصعد وتجعله هذه العقبة يشعر؟. فمثلاً، لنقل أن المشهد الأول في الرواية، يبدأ بأحمدٍ حشران، يريد الحمام.
لكن بسبب إعاقته الجسدية، لا يستطيع الذهاب، فيتردد ثم ينادي أباه لعله يأتي ويساعده. ولكن لا أب يجيب، فقرر إن يأتي بالهاتف ويتصل عليه، فنظر إلى جواله على الطاولة، قريب ممكن أن يصله لكن ليس بسهولة، وأكيد مع آلام عديدة ( ملاحظة: هنا عندك فرصة تظهر شوي من الشخصية، ماذا سيفعل أحمد، سيخبرنا شيء عنه: أسوف يحاول وصول الهاتف فوراً؟ أم سينادي أباه مرة أخيرة، لعل وعسى أن يسمعه؟. ).
يأخذ الهاتف، يده وجسده يصرخان ألماً، يتصل على أبيه، لكن لا رد. يحاول ثانية، ولكن قبل أن يجيب (لن يفعل، ولكن لن يهم). لا يستطع حبسها أكثر، ويفعلها على نفسه. الآن لو ذهبت من المشهد هذا لآخر مباشرة، فأنت هنا لم تجعل العقبة مؤثرة. لم ندر تأثيرها على احمد، ماذا سيفعل. أسوف يحس بالإهانة؟ وأنه عالة؟ ويكره وضعه وحالته أكثر؟ ويمقت جسده الذي يحبسه الآن في حين كان مصدراً لهويته؟. فيجب على العقبة الجيدة، أن تكون مؤثر، ولكن هنا تنبيه مهم. ليست كل العقبات يجب أن تكون مؤثرة، فإن وقفت شخصيتك أمام كل صخرة وأمر صعب وناحت وصاحت، وتأثرت واستشعرت، سوف يتحول عملك سريعاً إلى ميلودراما تراجيدية. ولكن، العقبات التي يجب أن تظهر فيها تأثير، هي العقبات المهمة، العقبة التي تكون في صميم الفرضية، والشخصية، والصراع، والعالم. وليس الهدف من كل العقبات أن تكون هكذا (ولكن يجب على كل العقبات أن تظهر شيء عن شيء، فمثلاً عقبة معينة تبين نوعية العالم، وأخرى تبين جزء من الشخصية، وأخرى تبين وتوضح ثيم من الثيمات التي وضعتها).
ثالثا: هل العقبة منطقية.
وتكون منطقية العقبة على ثلاث:
• منطقيتها للقصة: هل العقبة تنبع من القصة؟ فمثلاً، في مثال خوينا أحمد، أكيد هذه العقبة (قضاء الحاجة) سوف يواجها في نقطة أو اخرى، وتشعر أنها تنبع من القصة، وليست مجبورة عليها. فمثلاً، افترض لو خوينا أحمد، في مشهد من المشاهد، يبغى يلعب لعبة على جواله مثلاً، واللعبة هذي كان يحبها قبل الحادثة، ولكن بسبب جسده، طبعاً ما يمديه يلعب. الآن هل هذه عقبة؟ نعم، هل سوف تأثر عليه؟ أكيد. ولكن هل هي منطقي أو لها علاقة بالقصة؟ لا. إذا تحذف. ومثال آخر، تخيل لو أن احمداً أراد أن يزور مدرسة اعتاد زيارتها، ولكنه بسبب جسده.. إلخ، ما يمديه يزورها، الآن لو طبقت الطبقتين، ستجدها تنطبق، فهي عقبة، ومؤثرة. ولكن هل لها علاقة بالقصة؟ لا. أتحذفها؟ نعم. ولكن يمكن ان تربطها بالقصة بسهولة، مثلاً أن تعجله وأبوه، كانا يزوران المدرسة بين الحين والآخر، ولكن بسبب تخلي أبوه عنه، لا يمكنه فعلها، ولن يعينه عليها لأنه تخلى عنه. إذا الآن صارت: عقبة (تحدي)، مؤثرة، ولها علاقة بالقصة.
• منطقية حدوثها: بأن تكون العقبة هذه قد تحدث في عالمك الذي وضعت قواعده وقوانينه، فمثلاً افترض افتتاحية الكتاب الأخير من الأغنية: نزلت السفن الفضائية على ويستروس، ودمرت البلاد والعباد. الآن هل هذه منطقية؟ لا.
• وهل العقبة هذه هي حقاً (بالنسبة للعقبة الكبرى، التي ستغير الشخصية) هي التي تضرب صميم الشخصية؟ وتتحدى جوهرها؟. فلو كانت عقبتك الكبرى، لا تتحدى جوهر الشخصية، ولا تهز عالمه. لن تكن ذات تأثير قوي على القارئ، وأي تغير بسببها سوف يجعله يشعر أنه غش، وأن الكاتب فعلها لأجل هدف معين، وليس (التغير) نابع من الشخصية وصراعاتها.
رابعاً: نتيجة العقبة.
هذه تكون أكثر: سبب ونتيجة. أي: ماذا اثارت العقبة من صراعات الشخصية( وهذه تختلف عن المشاعر، إذ أن المشاعر هو تأثير العقبة اللحظي. ولكن الصراعات هي كعواقب العقبة وتأثيرها على الشخصية)، أو أضافت عليها؟ وإلى ماذا ادت هذه الصراعات وكيف تغيرت الشخصية بسببها.
فعلى العقبة الجيدة، أثارة صراع، وإظهاره للقارئ؛ كأنك تلقي حطباً في ناراً مشتعلة، او تلقي الشرر لكي تشعلها. فمثلاً، خوينا احمد، وعقبته لن تكون كإضافة الحطب، بل الشرر. البذرة الأولى لتغيره، ووضعه على المسار لإثبات الفرضية، وصراعه معها.
مثل قطع يد جيمي، لم تغيره مباشرة. بل وضعت البذور لكي يتغير وكي يتساءل ويمحص نفسه وشخصه وحياته وهويته.
الآن، لو كانت العقبة بلا نتيجة واضحة، وحتى وإن حملت تأثير وتحدي وكانت منطقية، لن تكون جيدة، بقدر واحدة ذات نتيجة. فمثلاً، في مثال خوينا احمد، بعد أن فعلها على نفسه، وحالت عليه المشاعر السلبية؛ من عجز وضعف، وكراهية وخذلان….إلخ. ماذا سوف يتغير في أحمدٍ نتيجة لهذه العقبة؟ وليس بالضرورة أن يغير حالاً، بالعكس هذا سيء (غالباً). ولكن يجب على العقبة الجيدة، أن تترك تأثير، وتزرع بذرة تغيير. فمثلاً، احمد قد يقرر بعد هذا أن يتحفظ، شيء قد عارضه خلال الأسبوع الأول، أو قد يقرر أن لا يفعل، ثم نتيجة هذه ستظهر مع الأحداث. وستزرع أيضاً، في احمد الكره الأولي لأباه، لكي تتقدم مع فرضيتك أكثر وأكثر (الاعتماد على الاحباء نهايته الألم). وإن لم يظهر هذا الكره، او يدري به. فمثلاً، لو نظرت إلى الأغنية، وشخصية جيمي لانستر بالتحديد. ستجد أن شروطنا الأربع، تنطبق على عقبته الكبرى: قطع يده. والآن سنطبقها، ونرى كيف أثرت على الشخصية، وقادته والاحداث إلى تغيره (او بداية تغيره) في نهاية الكتاب:
أولاً: هل هي عقبة؟
نعم. قطع يده؛ يقطع سلطته، هويته، ومعرفته بالحياة وكيف يتعامل معها. فأتذكر وإن لم يخبني الظن، أن تيريون قال عن اخيه: أي مشكلة تحل بالسيف، ليست مشكلة. فهذا يوضح طريقة جيمي في الحياة، أنه أولاً فارساً، ثم الأمور الأخرى.
وهذه العقبة، تبرز الطبقة الأولى من الفرضية، لأنه لما فقد سيفه فقد سلطته وأجبر على تغيير طرقه.
ثانياً: هل للعقبة تأثير داخلي، وهل تثير مشاعر الشخصية؟.
نعم. تأثيرها الداخلي، يكون بأنها أجبرت جيمي على أن يتساءل عن هويته، ويغضب على سمعته وتأثيرها عليه الآن، فمع يده لم يهتم إن كان قاتل الملك أم لا. ولكن بدونها، رأى تأثير هذا اللقب عليه.
وتثير فيه أنواع شتى من المشاعر، مثل الألم وهذا طبيعي، والخذلان، وإحساس الغدر (من سيرسي لاحقاً) ويتساءل أهو الآن نصف رجل؟. وعن سمعته وأحقيته بالقلب، وكيف أن نيد ستارك لم يهتم بمعرفة لماذا، بل فقط نظر إليه كخائن غادر للعهد.
ثالثاً: هل العقبة وتأثيرها اللاحق منطقيان؟.
نعم. العقبة تنبع من القصة والاحداث السابقة، طبيعي من الذي قطع يده (نسيته) أن يفعلها، لأهدافه. وطبيعي أن تقطع يد في عالم الأغنية. وهل هي حقاً العقبة الكبرى التي تمثل التحدي الجوهري لجيمي؟.
نعم أيضاً. فلو، كانت العقبة أي شيء آخر، غير قطع يده. لما كانت بذات التأثير، كما قلت. لجيمي: هو سياف، فارس من حرس الملك. وليس لانستر، وليس حبيب سيرسي، وليس أب لأبنائه. بل هو سيفه. وسيفه وقوته كانا حياته، وطريقة فهمه للعالم، وهدفه من صغره. فلما أخذ كل هذا منه، أجبر على أن ينظر ويمحص كل حياته، ويصارع أعمق أفكاره وذكرياته. وأجبر على تغيير طرقه، وهذا كله يصب في بعده الثالث الذي سنتحدث عنه في سؤال آخر.
رابعاً: هل نتيجتها واضحة؟.
نعم. ما أثارت من صراعات جيمي، كانت عديدة. قلتها سابقاً فيما يغني إعادته. ولكن هل نتيجتها جيدة؟ وهل التغير بسببها منطقي؟.
أيضاً نعم: فلما أطر جيمي على أن ينظر للحقيقة، ويستعمل عقله لا سيفه لفهم العالم ومحيطه، وشعوره بالعجز. كلهم أجبروه على أن يتغير، ويتخلى عن سيرسي (بداية التغير). وسنرى هل تغيره جيد ومناسب لشخصيته في الكتب القادمة إن نُشرت.
السؤال التاسع: هل تعرف تفرق بين الصراعات وتعرف كيف تكتبها؟.
الشخصيات الجيدة (الرئيسية منها والمهمة)، هي الشخصيات التي تملك صراعات عديدة. فلأن القصة لا تكون في فارغ، بل في شبكة معقدة من: الأحداث، الشخصيات، الاهداف، النوايا، المحيط، العواقب، العادات والعالم وتاريخه، الماضي، الحاضر. فمستحيل على شخصيتك الرئيسية، أنّ لا تتصارع إلا مع الفرضية، بل الشخصية الجيدة تتصارع مع الكثير.
ولا يوجد عدد معين من الصراعات وكأنك تتأكد من قائمة طلبات، بل الصراع ينتج من: العوامل الخارجية (الشخصيات أخرى وتصرفاتها، العالم وتاريخه، المحيط والعادات والتقاليد) وعوامل داخلية ( نوايا الشخصيات الأخرى ورغباتها وتوقعاتها على شخصيتك هذه، تأثير ورأي الشخصية في العالم ونظرتها لتاريخه وعادات وتقاليد مجتمعها، نواياها ورغباتها الشخصية، واهدافها). كل هذا يكون ينتج ويدخل في جودة الصراع. والصراعات أيضاً، تحكمها الثيمات، فلا يجب أن تخرج صراعاتك عن ثيماتك (حالما تضع صراع؛ إن ناقشته وأفضت فيه، ولم تذكره ذكوراً عابراً، فأنت تجعله ثيم من ثيماتك). فمثلاً، وهنا حرق للأغنية حتى الكتاب الرابع: سيرسي لانستر.
سيرسي شخصية معقدة، شبكة من الصراعات والشبح الداخلي والاعتقاد الخاطئ. ولكنها أيضاً، مثالا ممتاز للصراعات وتأثيرها وتحليلها (شخصية عميقة تستحق التحليل، ولكن سأذكر هنا صراعاتها فقط، بعضها ليس كلها).
فأول صراعاتها، وهذا الأكبر مع الفرضية: هو صراعها مع السلطة نفسها، وفكرة أنها الأذكى، ولكن فقط لأنها أثنى (صراع أخرى محبوك مع الأول) فأنها تهمش ولا يعتبر رأيها. وهي الملكة الأحق والأذكى للحكم، ولكن الرجال الحمقى لا يرون ذلك.
ثم صراعها، مع السلطة أيضاً، وهو أنها تحب أبناءها (صراع آخر محبوك) وتريدهم أن يصبحوا الملوك، ويجلسوا على العرش، ولكنها أيضاً لا تريد أن تتخلى عن السلطة، ولو لهم. فتراها، رغم أنها تقول أن ما تفعله لأجل مصلحة أبناءها، فهو حقاً يفسدهم وأي قدرة وسلطة على الحكم مستقبلاً.
وصراعها مع حبها لنفسها، وحبها لأبنائها وبحها للسلطة، وحبها لحبيبها، كل هذا يدخلون ضمن صراعاتها، ثم صراعاتها مع تيريون وأبيها، فالأول تكرهه، وهو جزء من شبحها، والثاني جزء من اعتقادها الخاطئ وسببه. كل هذا وأكثر بكثير (ما هذه إلا نظرة سطحية عن الشخصية). تراه يحبك ويقال في الكتب الأربعة، وتراه أمامك من تصرفاتها وردود أفعالها.
السؤال العاشر: هل ثيماتك متناسقة ؟
والثيم هو: فكرة تعرضها وتأثيرها في قصتك، عبر الشخصيات والقصة.. إلخ. ولا يهم عددها، بقدر أهمية تناسقها.
فالثيمات الجيدة، ليست فقط موجودة في القصة، وليس جودتها بعددها بل بتناسقها مع القصة والعالم والشخصيات والفرضية. فمثلاً، الثيمات في الأغنية، كثيرة وعديدة، لكن كلها إما تدعم القصة والفرضية أو الشخصيات أو العالم. فمن ضمنها:
الحب، الغدر، الخيانة، الأساطير وتأثيرها على الحاضر، المسؤولية، الأمانة، الشرف، السلطة، العائلات والطبقية، والأديان وتأثيرها، والمجهول…
وأقدر أعدد لبكرا، لكن كل ثيمات الأغنية، إما تدعم شخصية، أو توضح الفرضية، أو تبين العالم.
فمثلاً، إن افترضنا نريد وضع ثيمات لقصة أحمد، ستكون عن: حتمية الألم من الأحباب، والغدر، والتخلي، والألم الجسدي، والعجز، والأمل…
الثيمات، لا تقال صراحة. بل تسنج في النص، في الحوار، في تاريخ العالم (بالنسبة لأحمد، في تاريخه الشخصي وعائلته). وقد تكون الثيمات، ليست نتيجة مباشرة من القصة، لكن من العالم أو ماضي الشخصيات، فمثلاً لو افترضنا أن جدة أحمد تخلت عن أبيه في صغره، فقد تكون إحدى ثيماتك عن تكرر الشر، أو شيء مشابه. ليست من القصة والفرضية مباشرة، بل من الشخصيات وماضيها.
وأيضاً: الثيم عكس الفرضية. ليس رأيّاً (هذا أو ذاك.) أو قانون أعلى في روايتك. بل يميل لكونه فكرة تعرضها. فمثلاً: الغدر في الأغنية، عرضت الفكرة هذه ونوقشت على مدار تقريباً كل الكتب الخمس، وفي كل مرة، ولكل شخصية. الطريقة والنتيجة مختلفة، وهذا ما يميز الثيم. فلو كانت فرضيتك هكذا: إذا هي سيئة. فقلنا أن الفرضية كالقانون الأعلى في روايتك، لا تحتمل أو تسمح للعصيان. ولا يوجد قانون في كل الكون، يظهر نتائج متعددة.
بينما الثيم، يعتمد على الحدث، والشخصية؛ وماضيها وصراعاتها، وأهدافها. وعلى العالم والمحيط، لكي يعطي تأثيره.
السؤال الحادي عشر: هل تعرف كيف تستخدم وتستغل فرضيتك؟.
قد تتساءل عزيزي، ألم نتكلم عن الفرضية واستخداماتها في السؤال الأول؟.
نعم ولا. فما سأقوله لا يمكن أن يوضح في السؤال الأول، ويجب أن تكون فاهم لكل السابق لكي تفهم هذا السؤال.
قلت أن الفرضية الجيدة، كالنور يرشدك عن ماذا تكتب، وكيف تكتبه. وتخبرك بماذا قبل وماذا بعد. ولكن الفرضية الجيدة أكثر من هذا بكثير. بل يمكن استغلالها لتكن كالمصفاة، تصفي بها كل أفكارك، وثيماتك، وصراعاتك، وأحداثك، وعالمك، وشخصياتك، وعقباتك، وكثير.
فدائماً، عندما ترى صراع، ترى عقبة، ترى أي شيء على الصفحة. اسأل نفسك سؤال، هل لهذا علاقة بالفرضية؟ أيثبتها؟ أيوسعها؟ أيتعمق بها؟.
فالفرضية يجب أن تكون العدسة التي تنظر بها لما كتبت، وما سوف تكتب.
باعتقادك كيف تكتب وتحدد الاسئلة الثمان السابقة؟ وكيف تختبر جودة افكارك وتنتقدها، وتختار أفضلها وتترك سيئها؟
بالخبرة؟ لا. بل بالفرضية. الخبرة تفيد لا ينكر هذا عاقل، ولكن الفائدة الكبرى للخبرة تكون في التنفيذ وتقل في التفكير والاساس. فالأساس واحد، والابداع عديد. وكعبور النهر، الفكرة الواحدة قد ينفذها عشر بعشر طرق مختلفة.
فإن اردت ان تقف عند الفكرة، أضمن لك لو فكرت في السابق وكتبته ووضحته، سوف تتحسن فكرتك بعشرات المرات، ولكن لو اردت ان تكتب قصة، فتسلح بالفرضية وأنطلق فأمامك الكثير عزيزي. والسابق قواعد قد تحسن تنفيذها وقد لا تفعل، لا يمكن أن تجتاز اختبار كهذا، أو أي اختبار آخر. ويضمن لك ان تكتب قصة عظيمة.
فيجب ان تخل افكارك بالفرضية، كما يخل الدقيق بالمصفاة، فتمنع عنك الفرضية ما يفسد قصتك، ولا تترك إلا ما سوف يقويها ويساعد في اثباتها.
السؤال الثاني عشر: هل نهايتك تربط كل المهم وتجيب عنه؟.
فالمهم هو: الفرضية، والصراع الرئيسي معها. بغض النظر عن النهايات المفتوحة، يجب على نهايتك أن تجيب على الفرضية، وأن تبين تأثيرها (الصراع الرئيسي). فأفترض أن فرضية أحمد: الاعتماد على الأحباء نهايته دائماً الألم. انتهت القصة، ولم يجب الكاتب عنها، فأظهر ألم أحمد الجسدي، وتأثيره النفسي، لكن لم يتطرق لأحبائه وألمه من فراقهم وغدرهم أبداً. هذا لا يطبق فرضيته، ولن تفهم هكذا (لو قرأتها) وسوف يشعر القارئ أن القصة هدفها فقط تعذيب أحمد، لا غير. وليس استكشاف رأيي الكاتب في موضوع معين. وأفترض مثلاً، أن الكاتب تطرق لهذا الأمر، فأظهر غدر أخت وأبو أحمداً له، ولكن لم يظهر تأثير هذا الغدر غير بكاء أحمد وحزنه، ولم يغير هذا الفعل شيئاً في أحمد. أو قال الكاتب أن احمداً تغير، بسبب ما حدث، ثم لم يظهر هذا التغير. فهذا كله يضعف القصة والنهاية.
والنهاية الجيدة هي التي تربط كل السابق، ولما تقرأ بدايتها تشعر بـ آها، عشان كذا كان البطل يسوي كذا، ويشعر بكذا.
السؤال الثالث عشر: هل عالمك يدعم: فرضيتك وصراعك، وثيماتك، وشخصياتك ونموها، حبكتك؟.
العالم الجيد، هو العالم الذي يشعرك أنه السبب. أن لولا هذا العالم، وهذه الظروف لما حدث كل هذا. فإن أشعرت القارئ بأن العالم هو السبب، إذا بالفعل عالمك جيد. لا “بعمقه” ولا بعدد أعراقه، ولا بتاريخه الذي يمتد لآلاف وآلاف السنين.
لكن، هذا السؤال قاصر، وشرحه كذلك. وأنتظرونا في جريدة العوالم، حيث سأشرح فيها أساسيات العالم الجيد، وأمور أرى أن حتى أشهر ما قرأت لم تعتبرها وهي أساسيات مهمة جداً لكتاب الفانتازيا.
وبس.